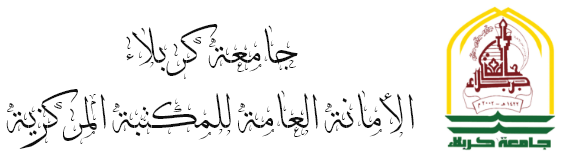| عبد الهادي فليّح حسن الكعبيّ | فلسفة في( لغة القرآن وآدابها) |
الخلاصة
اللُّغَةَ نظامٌ غايته التواصل وأداته العلاماتُ الدالةُ والرموزُ الموحيةُ والحروفُ المعَنويةُ التي تحملُ في طياتِها دلالاتٍ خفيةٍ قد تكشفُها دَلَالَةُ النصِّ، فأيُّ صوتٍ أو حرفٍ زيدَ أو حُذِفَ من لفظِ أو قُلِبَ أو أُبدِلَ بصوتٍ أو بحرفٍ انزوى وتغيّرت دلالةُ ذلك النصِّ لانزياحِ أو تغيير في ذلك اللفظِ الَّذِي أصابَهُ التغييرُ في بنيتِهِ؛ لِذا ركّزنا بدراستنا تلك على روايات المعصومين (عليهم السلام) مُعتمدين بذلك على دلالة توجيه العلّامةِ المجلسي لرواياتهم (عليهم السلام) في كتابيه العلم والتوحيد، ليكونَ كلام المجلسي وتوجيهه البوصلة التي نتحرك من خلالها لنصلَ إلى الدلالة المنشودة جاعلين المباحث اللغوية من صرف ونحو ودلالة طريقنا الذي نسلكه وغايتنا التي ننشدها.
وقد تميّز كتاب بحار الأنوار بأنّه كتابُ نقلٍ لروايات المعصومين (عليهم السلام) وأحاديثهم، ولم يقف المجلسي عند النقل بل أوجدَ تفسيرًا يكادُ لم يكُنْ معمولًا به في عصرِهِ وهو تفسيرُ آياتِ القرآنِ الكريم موضوعيًا؛ إذ يأتي بالآية التي ترتبط بالموضوع كأنْ يأتيَ بآياتِ التوحيد في موضوع التوحيدِ ويشرحها شرحًا موحدًا، فضلًا عن ذلك، وقد تميّزَ بميزةٍ جعلَتْهُ ذا قيمةٍ قد ضاهَ بها أُمّاتِ كتبِ الحديثِ هِيَ إحاطتُهُ بالروايةِ والحديثِ، وقدرته عَلَى معرفةِ سقيمِ الحديثِ من صحيحِهِ.
وقد كَثُرَ في كتاب بِحَار الأَنْوار تفسيرُ المباحثِ اللغويةِ وشرحِها وبيانِها صرفيةً كَانَتْ أم نَحْويةً أو دلاليةً وتلك الطريقةُ وذلك المنهجُ لم نعهدْهُ ونجدْهُ في أكثرِ كتبِ أحاديثِ الشيعةِ ورواياتِهم، فقد ذُكِرَتِ اللُّغَةُ ومباحثُها فضلًا عَن جمعِ وذكرِ الأحاديثِ والرواياتِ؛ إذ إنَّهُ جمعَ بين التأصيلِ والبيانِ.
ولم تكُنْ آراء العلّامة المجلسي في مباحث الصوت وتصويباتُه ونقودُه وبياناتُه وتقويماتُه كالتي وجدناها في مباحثِ الصرف والنحو والدلالة، فقد كانَ فيها ناقلًا للآراء غيرَ موجّهٍ تابعًا غيرَ مُبررٍ فكانتِ المسائلُ التي أحصاها الباحثُ لا تتعدى الخمسُ والثلاثون مسألةً، فضلًا عن ذلك قد كَثُرَتْ نقودُ الناقدين على مؤلِّفِ البحارِ بأَنَّهُ بصيرٌ بالأحاديثِ والروايةِ ولكنَّهُ ضيقُ الأفقِ في الفلسفةِ وأمورِها مما أوقعَهُ ذَلِك في أخطاءٍ جعلَتْ من المؤلَّفِ محلَ نقدٍ واستفسارٍ، وهو ما لم يجده الباحث صحيحًا فلَيْسَ من الإنصافِ عدَّ العلامةَ المجلسي من الَّذِين ينقلون الغَثَّ والسمينَ فهُوَ ناقلٌ مُدققٌ لم ينقلْ من الأحاديثِ إلّا ما ثبتتْ رصانتُهُ فهُوَ الَّذِي يمعَنُ النظرَ في صغيرِ الأمورِ وكبيرِها، والغلّامة فيها يُكثرُ من أسماءِ الرواةِ في بحارِهِ لتقويةِ ما نقلَهُ ويتركُ ما لَمْ يَكُنْ مُطابقًا للمشهور، وما يأخذ من الروايات إلّا من أصلٍ مُعتبرٍ وحديثٍ أصيلٍ.
ونجدُ العلّامة المجلسي في أكثرِ المسائلِ اللغويةِ قد سكتَ عَن إِبْداءِ رأيه؛ لأنّها بُحِثَتْ ونُقبتْ فلا حاجةَ له فيها، وقد سلكَ الْعَلَّامَةُ المجلسي طريقًا اتّبعَ به اللغويين؛ إذ لا يحكمُ عَلَى النصِّ ولم يُعطِ دَلَالَتَهُ ولم يفسرْهُ إلّا بعد عرضِهِ عَلَى مجهرٍ مُكبرٍ وناظورٍ مُبيّنٍ يعرفُ بالدَلَالَةِ الصرفيةِ أو المعَنى النحوي أو الدلالي، ونجدُهُ في بَعْض المباحث اللغوية يميل إلى الإيجَاز غير المُخَلِّ.
أمّا في المباحثِ النحويةِ فلم يتبعِ الْعَلَّامَةُ المجلسي مذهبًا نَحْويّا مُحددًا ولَمْ يَكُنْ مُتعصبًا لمدرسةٍ معينةٍ ولم يتّبعْ منهجًا من دون آخر ولم يصنّفِ النحوَ إلى بصري أو كوفي، بل جمع بين المذاهبِ فأخذَ الرأي السديدَ وتركَ الاختيارَ والتحديدَ، ونلحظُ قلةَ الاستشهادِ بالشعرِ العربي في بِحَارِ الأَنْوار، لنجدَ له العذرَ؛ فالكتابُ كتابُ روايةٍ جمعَ به أحاديثَ المعصومين، وتلك الأحاديثُ أخذَتْ من القرآنِ الكريمِ مادتَها الأساس؛ لِذا نجدُهُ قد أكثرَ من الاستشهادِ من القرآن الكريم، فأنمازَ منهجُهُ في البحارِ عمّن سبقَهُ من اللغويين الَّذِين جعلوا الاستشهادَ بالشعرِ مطيتِهم فأكثروا منه قِيَاسًا بما استشهدوا به من القرآن الكريم، ولم ينتهجِ الْعَلَّامَةُ المجلسي في ترجيحِ أو تفنيدِ آراء اللغويين منهجًا مُشتتًا مُبعثرًا، بل اتخذَ بذَلِك مسارًا قويمًا ثابتًا قد جعلَ أسسَ الاختيارِ الرصينةِ من السماعِ والقِيَاسِ واستصحابِ الحالِ وما اجتمعَ عليه اللغويون سبيله الَّذِي ينفذُ منه، أمّا الباحثُ فلم يُرجح في تحليلاتِهِ لأيِّ كتابٍ مسؤولٍ عَن نقلِ الأحاديث والروايات وشرحها؛ لا لأنّه امتنع، بل لم يجدْ ضالتَهُ التي بحثَ عَنها.